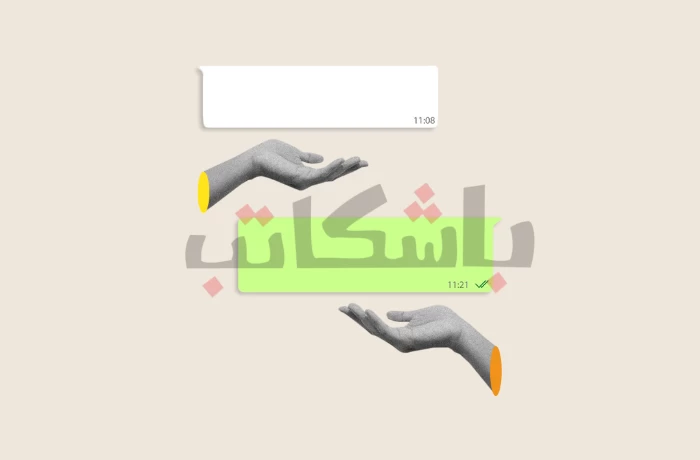حين ينطلق الأذان بتكبيرات العيد مُعلنًا عيد الفطر، تتشابه القلوب وتختلف الملامح، فرحٌ واحد يتسلّل إلى الأرواح، لكنه يتّخذ وجهين؛ وجه المدينة المتسارع، ووجه الريف الهادئ.
وبين الزحام والسكينة، يتشكّل العيد كحكايتين متوازيتين لا تتقاطعان إلا في التكبيرات، ثم ينفصلان إلى عالمين؛ لكل منهما بهجته، ولكل منهما حزنه الخفيّ.
في المدينة، تبدأ بهجة العيد منذ اللحظة الأولى، حيث تُضاء الشوارع بواجهات المحلات، والأطفال يتحركون بخفة في ثيابهم الجديدة، ينظرون في المرايا كأنهم يكتشفون أنفسهم من جديد، في الساحات تصطف العائلات للصلاة، تتبادل النظرات والضحكات والتهاني.
النساء والفتيات يذهبن إلى المُصلّى، يفترشن الساحات، يرددن التكبيرات في صوت جماعي يملأ المكان، يشعرن للحظات أنهن جزء من المشهد العام للعيد، أنهن مرئيات، مشاركات وحاضرات.
لكن العيد في المدينة يشبه الألعاب النارية، لحظة بريق ثم يختفي، غير أنه لا يُنسى، فبعد الصلاة، تبدأ قيود غير مكتوبة في الظهور، تُفضّل النساء والفتيات البقاء في البيوت، لا يخرجن إلا بصحبة العائلة أو لمشاوير قصيرة، حيث يشتد الزحام وتبدأ الفوضى. يصبح الشارع خطرًا غير معلن، فتُغلق الأبواب على العيد، ويظلّ العيد داخل الجدران.
أما في الريف، فالعيد له طقوسه القديمة التي لا تعرف الاستعجال، تبدأ الفرحة بتلك الثياب الجديدة التي تم تخزينها بحرص قبل العيد بأسابيع، تُخرَج ككنزٍ محفوظ، تُفرد على الأسرّة، وتُرتّب بعناية كأنها إعلان رسمي بقدوم العيد، كل زرّ، كل تطريز، هو قصة تُروى.
ومع الفجر، تخرج النساء والرجال لزيارة المقابر، تتهادى الخطى نحو المقابر، يحملون زهورًا، وأطباقًا من الطعام، وفواكه مقطّعة بعناية، وقلوبًا تئن بالحنين، يُوزَّع الطعام على الناس كصدقة، وتُقرأ الفاتحة، وتُتلى الأدعية. هناك العيد يبدأ بزيارة الغائبين، وكأن الأحياء لا يكتمل عيدهم دون إشراك الموتى في فرحتهم، ثم يعودون لاستقبال العيد.
وبعدها يأتي دور الصلاة؛ يخرج الرجال والأطفال إلى الساحة أو المسجد، بينما تبقى النساء في المنازل، ففي القرى، لا تُصلّي النساء العيد في المساجد كما في المدن، بل يكتفين بسماعه عبر مكبرات الصوت، أو من خلال حكايات العائدين، هناك يبدو العيد وكأنه شأنٌ رجالي، يخرج الكبار والصغار من الذكور، بينما تظل النساء بين الجدران، يراقبن المشهد من النوافذ.
أثناء الصلاة، تبدأ النساء بتجهيز الكعك، وتُزيّن الأطباق بالسكر واللب والسوداني، ويُقرع الباب من آنٍ لآخر، يحمل كل جار طبقًا ويعود بآخر، الفرحة تُصنع يدًا بيد، والرائحة مُعبّقة في الأجواء كدعوة جماعية للبهجة، لا صور تُلتقط، ولا منشورات تُكتب، بل ذاكرة حيّة تُخزَّن في القلب.
وبعد الصلاة، حين يركض الصغار في الشوارع الواسعة، لا يُسمح للفتيات بالمشاركة، العيد بالنسبة لهنّ لا يعني الجري وراء الأصدقاء، ولا اللعب في الساحات، ولا حتى ركوب الدراجات مثل الصبية، فالعادات والتقاليد تمنعهن، وكلمة "عيب" تسبق كل محاولة للخروج من هذا القيد، "عيب البنت تطلع برة"، خاصة إذا كانت قد اقتربت من سنّ المراهقة، وكأن الفرح له حدود، وكأن الركض حكرٌ على الأولاد.
أو كما يقول الشاعر، نصر الدين ناجي، في الأغنية التي صدح بها المطرب محمد منير:"شباك موارب من وراه واقفة الصبايا.. قضوا النهار في الوقفة قدام المرايا".
وفي المساء، حين يهدأ الزحام، سواء في الريف أو المدينة، يجتمع الجميع حول الطعام، الفسيخ، والرنجة، والملوحة، لهم حضور ثابت، يتشاركها الجميع على اختلاف أماكنهم، وبينما ينشغل أهل المدينة بمشاركة صور العيد، يجتمع أهل الريف على القصص، يضحكون ويتسامرون، وكأن العيد هناك لا يُشبه الوميض، بل يُشبه الضوء الهادئ الذي يستمر طويلًا، حتى بعد انتهاء أيام العيد.
في النهاية، يبقى العيد عيدًا، لكنه يتشكّل بما حوله، ففي المدينة، الفرح يركض ثم يتوقف عند أبواب المنازل، على عكس الريف ففيها الفرح يتأنّى، لكنه محدود بخطواتٍ لا تتجاوز العتبات، وبين الركض والتأني، قلبٌ واحد يُردّد: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد.