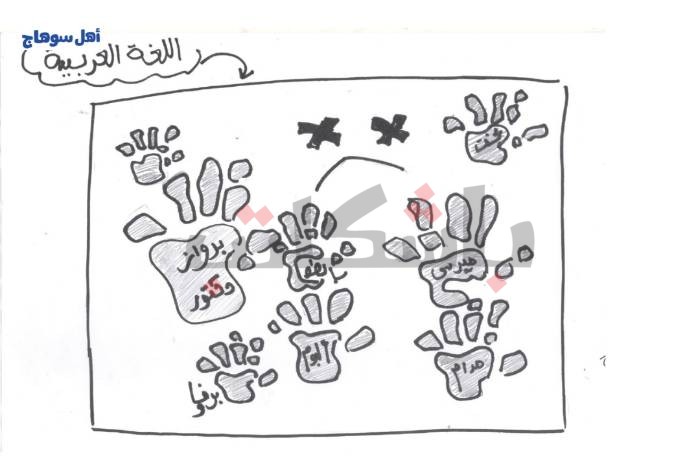العيد في الماضي له نكهة فريدة تُطلّ على الحي ببهجته وألوانه وصوته، كان في قلب تلك البهجة رجل بسيط يُدعى "عم حسنين" بائع الألعاب، لم يكن يملك متجرًا فخمًا، بل كان يمتلك عربة خشبية مزينة بأشرطة ملونة، تتمايل كلما مر بها النسيم، تعلوها ألعاب بسيطة، بالونات ملونة، صُفّارات تصدح بضحكة دمى خشبية بأذرع تتحرك بخيط، وكرات زجاجية تشع بألوان الطيف.
كان الأطفال ينتظرونه بشوق كل عام، يركضون خلف عربته، تتلألأ عيونهم بالفرح، وكأنهم يرون العيد فيه، كان عم حسين يبتسم دائمًا، ويمازحهم ويمنحهم الألعاب، كأنه يمنحهم قطعة من قلبه.
لكن مع مرور الزمن، تبدّلت الأحوال وظهرت الألعاب الحديثة بأصواتها اللامعة وشاشاتها الصغيرة، حيث توفر الهواتف الذكية جميع أنواع الألعاب الممتعة التي تجعل الأطفال لا يكترثون إلى الدمى والألعاب غير التكنولوجية.
مع التطور اختفت البساطة من حياة الأطفال، كما اختفت من عربة عم حسنين، فجلس يومًا ينظر إلى ألعابه التي لم تعد تُغري أحدًا، وقلبه مُثقل بالحزن، وفي أحد الأعياد لم يأتْ إليه طفلٌ واحد، فقرر التوقف، طوى الأشرطة وأغلق العربة.
مرت الأعوام وذات عيد لمح عم حسنين مجموعة من الأطفال يجلسون بهواتفهم الصغيرة، بلا ضحك أو حركة أو صوت، خطرت على باله فكرة، فعاد مُسرعًا إلى عربته، وقف أمامها يربط على خشبها بيده، كأنما يوقظها من سباتها الطويل، مرر أصابعه على الأشرطة الباهتة، فتذكر ضحكات الأطفال وأصواتهم التي كانت تملأ الحي، ثم تنهد طويًلا، وكأن قلبه يفيض بحنين السنين، وأخذ يجددها قطعة قطعة، وكأنما يجدد شيئًا في داخله.
تمكن عم حسنين من عودة العربة إلى الحياة، حيث أضفى لمسة جديدة جمع بين الماضي والحاضر، دمى ميكانيكية ترقص، بالونات تضيء، وصفارات تغني.