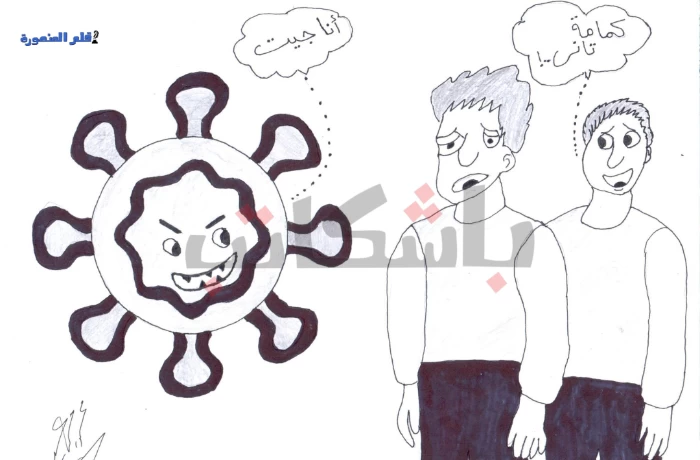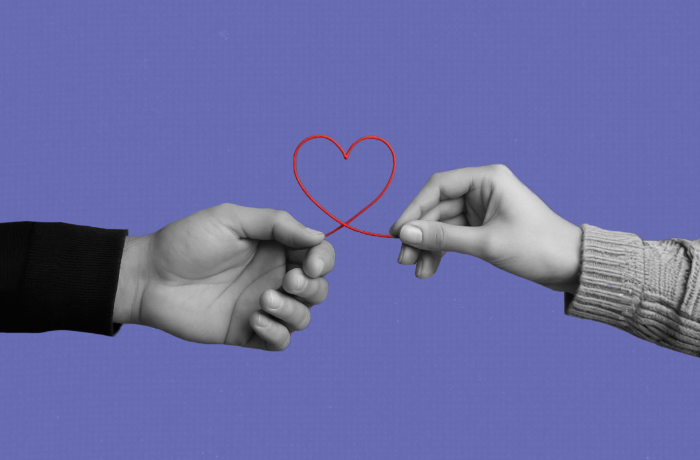ترسم دون معايير، هي فقط تستخدمني كباب للدخول لما تفكر فيه، فأنقله لها أنا على أرض الواقع، الفنانة التي تمتلكني لا تهتم بأية قواعد، لكنها ترسم كثيرًا.
فها نحن نرسم إحدى اللوحات الجديدة، دائمًا ما أرغب في مشاركة رأيي في محتوى اللوحة، أغضب لأنها تتعامل معي كأداة رسم فقط، لكن اللوحة الجديدة ضمّت صخب الانفجارات وضياء النيران ورائحة الدماء.
أنظر حولي، فيما تستمر هي في اصطحابي على الورقة البيضاء للوحة لأخط خطوطًا جديدة، فأجد رسومي تحيطها من كل جانب، وأنا وحدي أعلم قصة كل لوحة.
هنا، امرأة جميلة ذات شعر مجعد قصير وهيئة ممتلئة قليلًا، ترتدي بيجامة منزلية، وتقوم بإعداد الطعام، فيما تنتظر عودة أولادها وزوجها، أحببت هذه السيدة منذ أن حددت خطوط شخصيتها، أعرف أنها جاءت من عملها مبكرًا، لتنتظر أطفالها بعد أول يوم دراسة، أحضرت الكثير من أصناف الطعام التي يحبها أطفالها، كم هي أم حنونة.
وفي الأعلى، اللوحة التي رسمناها قبل أسابيع، ورغم ما بها من أضواء وزينة وأصوات موسيقى راقصة، إلا أنني أعلم قصتها الحزينة، قصة الفتاة ذات الشعر الطويل، التي ترتدي فستان جميل أبيض، وكل شيء حولها يبدو مدعاة للفرح، إلا عيناها ذات الـ16 عام، التي تذرف دمعًا تخفيه عن الحضور.. لأنها العروس.
وفي الزاوية أسفل الشباك الأخضر لحجرتنا، لوحة الرجل الأربعيني، الذي يرتدي قميصًا وبنطالًا رسميًا، ويحاول اللحاق بأتوبيس النقل العام، وسط زحام الشارع، تلك اللوحة المدفوعة بهرولة بطلها، مُحمّلة بهموم الحياة اليومية، للموظف الذي أعلم أنه يحلم بشراء سيارة، ورغم وظيفته التي يُفترض أن تكون مرموقة، لن يتمكن من ذلك لأنه غارق في الأقساط.
لا ينتهي شعوري بالحزن على ذاك الرجل، إلا بالنظر للوحتي المفضلة، أذكر أننا انتهينا من رسمها كاملة، في يوم واحد، لوحة الأطفال الذين يلعبون، وهم يرتدون فساتين وملابس جديدة، وسط ألوان البالونات.
أستطيع شم رائحة الأجواء وتخيلها، إنه العيد.
كنت أُفضّل أن تتوسط تلك اللوحة الجدار وحدها، لكن فنانتي لن تستمع إليّ، فقط قررت أن تضع رسمة السيارة البلاستيكية المُلقاة على جانب الطريق الممطر، بجانب رسمة العيد، لتدفع بعد شعور الفرح في التفكير في ذلك الطفل الذي قرر تحمل المسؤولية، تاركًا لعبته على قارعة الطريق.
نعم، رسمنا الكثير والكثير من اللوحات ولكل لوحة فيهم قصة لديّ، هم في الحقيقة عالمي الذي لا أعرف سواه ومالكتي الرسامة الشابة التي تأتيني وحيدة في مرسمها الصغير، وإلى اليوم لا أعرف اسمها.
وأفكر في اسمها، ماذا قد يكون؟ وبينما كانت تحتضنني أناملها، وهي تمرّ على الورقة البيضاء، لرسم خطوط جديدة، أشم فيها رائحة الحريق والدخان والدماء، فجأة، وللمرة الأولى، لم يكن شعوري باللوحة صحيحًا.
تلك الرائحة، ألوان النيران، صوت التحطم وصراخ الأطفال، لم يكن مصدره الرسمة، بل امتد من الخارج ليصل إلينا، احترقت لوحة السيدة، والموظف، توقفت أناملها عن جرّ رأسي على اللوحة البيضاء، بدأت اللوحات تسقط، رائحة الدخان تزيد، حتى وصلت النيران للمرسم.
وللمرة الأولى، أرى العالم حول المرسم، الجميع يصرخون، الدماء هنا حقيقية وليست على أرضية اللوحة، تحترق لوحة العيد، يحترق الموظف بأحلامه، تحترق العروس وفرحها بمدعُوّيه.
وقبل أن أسقط سقوطًا حرًا من يدي رسامتي، سمعت اسمها لأول مرة: يافا.. ياافاا، هكذا سمعت من يصرخون فيها، قبل أن يصطحبوها، وألوان الدماء تُلطّخ ردائها الجميل.
هي لا تريد أن تذهب بعيدًا عن المرسم، لا تريد الرحيل، ولا أزال أستطيع سماع أفكارها، أخبروها أنني هنا ما أزال في انتظارها.. في انتظار رسم جديد لـ"يافا".