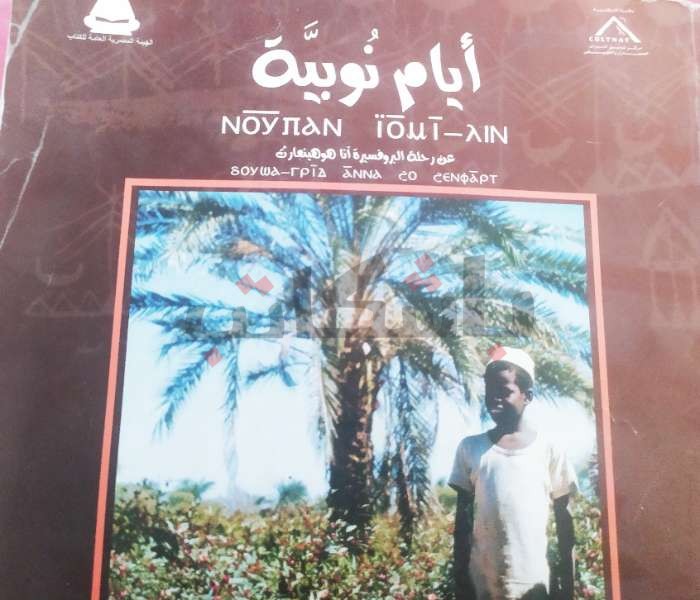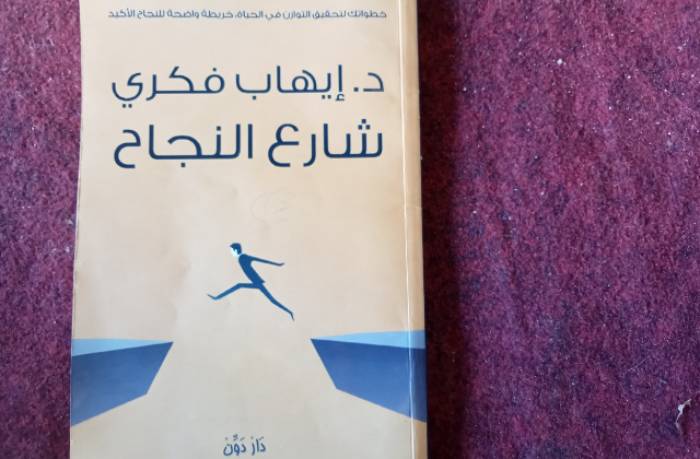فى العاشرة مساءً نجتمع؛ أنا وإخوتي، أمام فيلم الملك الأسد، مرتدين بيجامات العيد الجديدة، وتفوح منّا رائحة "شاور جيل الياسمين".
لا زالت مقدمة رأسي تؤلمني أثر معركة أمي مع شعري وأختي منذ قليل التي انتهت بعمل فني بمزيج من الضفائر"البلح"، أما اخواني فما زال أيضًا أثر موس الحلاقة يترك علامة حمراء على "قفاهم"، هادئين عقب وصلة من الاعتراض على "قصة الشعر" المعتادة التي يختارها لهم والدي كل عيد. ينتهي الفيلم، لننتقل إلى سرائرنا بملاءاتها الجديدة المتوسمة برسومات "هالو كيتي"، نحلم بفسحة أول يوم العيد، و غنيمتنا من العيدية.
قبل الصلاة نستيقظ، نرتدي عباءة العيد، اتجادل مع أختي على طرحة من دولاب امي، أفوز أنا بـ "البينك" وهي بـ"التركواز"، بينما يرتدي اخواني جلاليبهم البيضاء وتفوح منهم رائحة عطر أبي، أجري لأخذ كحكة من علبه الخبيز وأدسها في قبضة يدي كي أستمتع بها وأنا في طريقي للمسجد، الذي نعود منه بحصيلة جيدة بين الحلوى والبلالين والدعوات بالنجاح وبأن ربنا يبارك فينا.
وبعد عودتنا يأتي طقسي المفضل؛ كوب الشاي بلبن، تفرج معها أخيرًا أمي عن علبة المخبوزات، وتسمح لنا بتناول ما نريده.
وفي الغذاء، نلتم على السفرة بالأكلة المشهورة هنا فى أسوان، السمك، بينما فى أنفسنا حقيقة ننتظر العشاء، ليكون فى مطعمنا المفضل للبيتزا.
لم تنتهي بعد معارك أمي مع شعورنا، فتعود مع أخرى، ونستسلم نحن أيضًا مرة أخرى تمامًا، بينما تضع لنا فيونكات ملونة، ثم تفتح علبتها الحمراء القطيفة من الدولاب وتضع لكل واحدة منا خاتم دهب وسلسلة "ما شاء الله"، لنخرج "في أبهى حلتنا"، وتتداخل ضحكاتنا مع صوت همهمات أمي ترقينا من العين.
المحطة الأولى عند جدتي لوالدي، حيث يبدأ عرض الأزياء بين أبناء العائلة، كل فرد يستعرض طقمة المميز، بينما توزع علينا جدتي بسكوت الشمعدان الاحمر، وغنيمتنا الأولى من العيدية، التي ندسها سريعًا فى جيوبنا، ثم نتجه إلى محطتنا التالية عند جدتي لأمي، الذي يبدأ بـ سيشن تصوير من خالتي لي مع بنات خالتي، وكل مرة نحاول اختراع وضعيات جديدة للتصوير. ثم نتراص لاستلام غنيمتنا التالية من العيدية.
أما محطتنا الأهم فتكون فى "الملاهي"، حيث نتوجه جميعًا إليها، ولابد طبعًا من التشاجر سويًا على لون المركبة في لعبة الساقية، يريد أخي اللون الأزرق بينما اريد انا الزهري مثل ملابسي. ونقف في طابور عربات التصادم، في يدي غزل بنات واخرج لساني لاخوتي الذي اصبح لونه احمر.
لا يزال اول يوم للعيد حاضرًا في خيالي بكل تفاصيله وروائحه ولحظاته السعيدة، التي كانت سببًا فى بهجته.
أفكر اليوم واتساءل؛ هل جميع هذه الطقوس هي من كانت تسعدنا أم الحياة وقتها كانت أبسط مثل أحزاننا، التي كان يمحوها مجرد قطعة حلوى. فكرت في كلمة قالتها اختي الصغيرة: "احنا في ذكريات خلاص مش هنعرف نعيدها تاني"، وأجدها رغم وجعها حقيقة، بعدما تفرقنا أنا واخوتي بسبب الدراسة ومشاغل الحياة بعد أن كان يجمعنا سقف واحد، وباتت مكالمة فيديو كول!.
اليوم؛ في عيدي الثالث والعشرين لأول مرة لا أشعر ببهجة العيد، بل نعيشه فى قلق بينما اخواني الاولاد في السودان يعيشون في حرب بين أصوات طلقات النيران والقذائف. أغمض عيني كل ليلة وأنا أتمنى أن أستيقظ لأجد كل هذا حلمًا وأنني مازلت هذه الطفلة الصغيرة التي تشاهد فيلم الاسد الملك و نرتدي بيجامة العيد الجديدة و تفوح منها رائحة شاور جيل الياسمين مع جميع أفراد عائلتها.